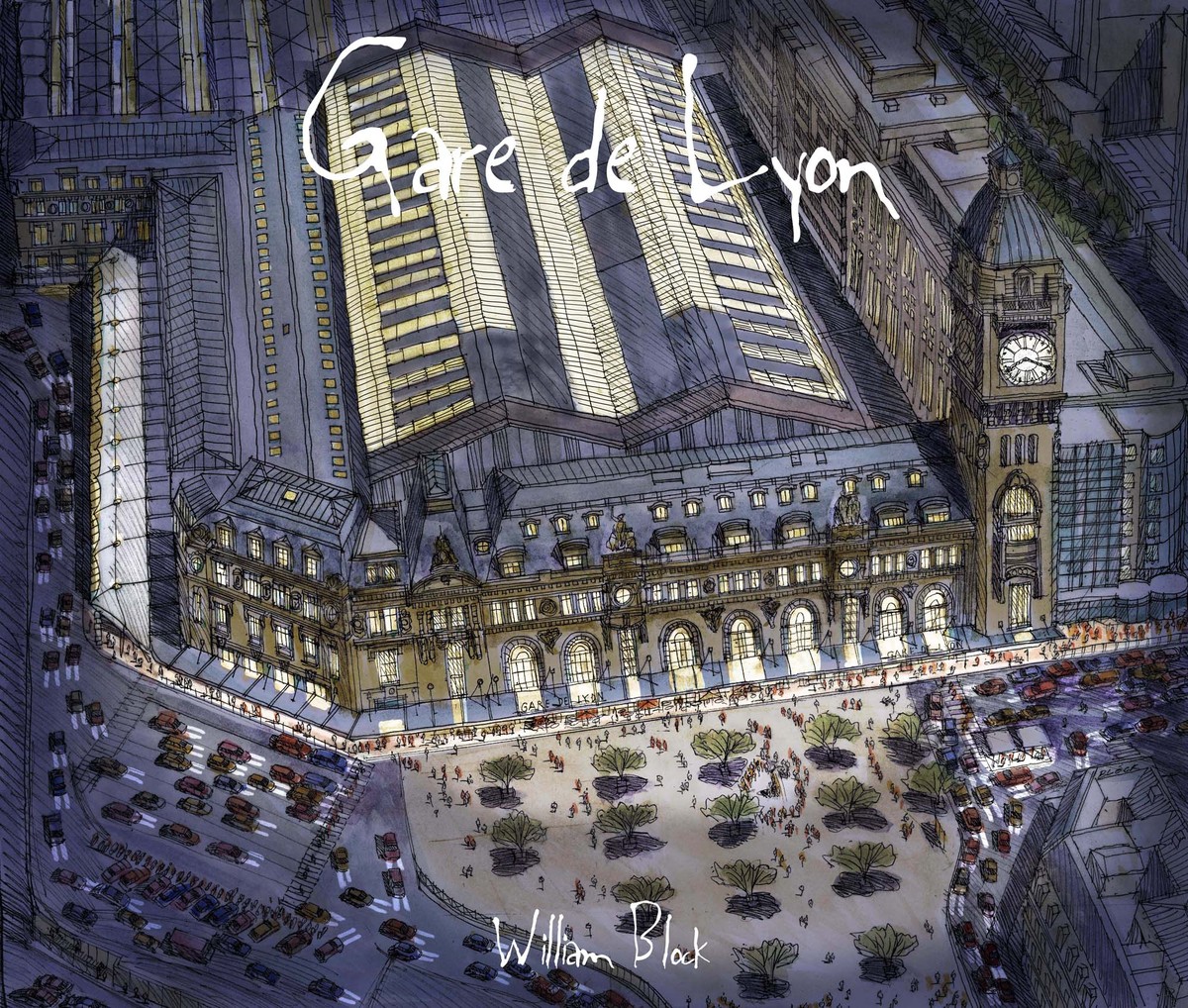عندما تلتصق بك عادة، يصعب عليك الانفصال عنها. تجد نفسك قاطعًا ما أنت مستمتع به لتنفيذ ما اعتدت عليه. داخل مدينة أورلاندو، تلك المدينة الغرائبية، والتي أصفها بتلك الصفة لا تعبيرًا عن ابهار يشد الناظر إليها، بل استغرابًا من هوية مفقودة تتكبد الكثير من العناء في بحثِ دؤوب عنها. شُيدت المدينة لغرض واحد، هو الترفيه لا غير. في خطة محكمة لجذب رؤوس الأموال الممكنة لإضفاء ازدهار ممنهج يجعل منها قوة جذب لنشاطات إنسانية أخرى. اُختير الموقع بدقة، فهو ينبئ بأحوال طقس ملائمة طوال العام، ضامنةً بذلك توافد السياح دون انقطاع يُنضب محفظة المدينة المالية. مدن ترفيهية تنقلك لعالم ظننت وجوده في كتب الخيال، غالبًا طفولية، فمن مثل الأطفال في إقناع الآباء المكلومين أحقيتهم بتلك الأموال. أردت الابتعاد عن كل تلك الملهيات لأجد نفسي متوجهة صوب ضاحية وينتر بارك. وهي منطقة أراد من خلالها السكان نسيان مدينة أورلاندو، وهو فعلًا ما تم لهم. حدائق شاسعة تمدها أشجار عالية بظلال لا حدود لها، لتمتهن مهنة أخرى خفية تتمثل في وضع حاجز بين البلدة وبين الضاحية. سكان تلك الضاحية يمارسون الركض في كل الأوقات. فالطرق غير مزدحمة، ومرصوصة بحجارة صغيرة تذكرك بتلك الأزقة لبلدة أوربية مطلة على البحر الأبيض المتوسط. مشهد يبدو دخيلًا بعض الشيء إلا أنه أضاف رونقًا جعل الكل مغمورًا بطاقة تم تحويلها للحركية منها متمثلةً في الهرولة. توجد سكة حديد لقطار لا يقطع مسافات طويلة، فما أن ينوي الرحيل حتى يعود مسرعًا لنقطة الانطلاق، لا أعلم الغاية المرجوة منه، إلا أنه أضفى خلفية جميلة لصورة الضاحية.
تترامى على جنبات وينتر بارك العديد من المقاهي. اتخذت إحداها ملجئًا لي، في إستمرارِ لفعلِ لا أقوى على محوه. صُمم المقهى بأبسط التصاميم ، فالمناظر الخارجية رفقة الكائنات الحية كفيلة بأن تجعل من كل مبنى شُيد على عجل جميلًا وأن لم يحاول في أن يكون كذلك، كل هذا دون تكلف يعقد من منظر المبنى. أخرجت اللابتوب لتبدأ معها رحلة الكتابة في أي شيء. أمعن النظر في الشاشة واشيح ببصري بين الفينة والأخرى صوب اتجاهات مختلفة، أُناس ملفتة، غيمة طافية، شجرة منحنية، أو حشرة تصيبني بالحيرة عن ماهيتها ودرجة الألوان المصطبغة على ظهرها. وبين هذه وتلك أحسست بدنو شخص من الخلف، بيد أني حاولت التنكر لهذا الأمر بالأخذ بعين الاعتبار أن مساحة المقهى صغيرة تحتم اقتراب الأشخاص دون قصد منهم. إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الفكرة بعد استماعي لكلمات تخرج من فمه حُملت بواسطة هواء مشبع، سارت على عجل ناحية أذني، وكرد فعل طبيعي لما حدث التفتُ لألتقي بمن احدث كل تلك الضوضاء. شاب طويل اشقر بلحية مبعثرة غير مهملة تعلوها خصلات ذهبية بدأت في التحول تدريجيًا ناحية اللون البني. “مرحبا، اسمي مايكل”. لوهلة انتابني حدس يشير بأن هذا الشخص مألوف لدي، أو لعل السبب يكمن في الأسم ذاته. فأسم مايكل يتم تداوله بشدة بين من يتبنون اللغة الإنجليزية مرفأً لهم، شبيهة بمعضلة اسم محمد في ديارنا. فأسماء الذكور لدينا مكررة بشكل كبير، وما أن تنوي الواحدة منا تجاوز أحدهم يظهر مسرعًا داخل تفاصيل حياتها اليومية؛ اسم شارع، شخصية في مسلسل تهم في متابعته أو اسم يبرز على شاشة الهاتف ينتمي لشقيقها الأكبر يلح في السؤال عن أحوالها وتوبيخها بلطف لقلة تواصلها معه وعدم التفاعل مع ما يتم إرساله داخل قروب العائلة في الواتساب. لابد من إحداث ثورة في أسماء الذكور كما هو الحال مع الإناث حيث لا تنفك تلك الأسماء بالتطور والاختزال في أقل عدد ممكن من الحروف. فما عاد هنالك أسماء مكررة تحتاج فيها لذكر الاسم الثاني أو الثالث، هي المرة الأولى التي تستمع فيها لهذا الاسم وهي الأخيرة حتمًا. بينما على النقيض تمامًا، هو يحمل اسم جده وجده يحمل اسم عمه وعمه سُمي على عابر طريق أحدث موقفًا رجوليًا نال من خلاله شرف تسمية ابن من قدم له يد العون ويا للمصادفة هذا الاسم يحمله جاره.
بالعودة لمايكل، في البدء لم أستغرب فعلته. فالرجل ينتمي للجنسية الأمريكية ومن أُسس تلك الهوية هو الحديث مع الغرباء، بل أكاد أجزم بأن من أفتعل هذا الفعل وجعله عُرفًا يتجنبه البعض ويستحسنه الآخرون هم الأمريكيون ذاتهم. رددت عليه التحية بشكل مقتضب رغبةً مني في إنهاء الحديث سريعًا فلا طاقة لي بأن أناقش أحوال الطبقة العاملة في بلدان أوروبا الشرقية. استرسل في نسج الكلمات معبرًا عن الطقس وعن جماليته في فلوريدا ومنافعه التي أدت لتحسين حالته النفسية، فقد قدِم من ولايات الشمال الشرقي، تحديدًا بنسلفانيا، حيث البرودة الشديدة والقاتلة لكل رغبة في الحياة. في المقابل كنت ثابتة على الكرسي دون حراك يذكر، وما من دلالات أبعثها تفيد باستلاطفي لهذا الحوار. لم أنطق بشيء يستدعي انتباهه، كل ما بدر مني كان كلمات بسيطة غالبًا مؤيدة لما يقوله، إلى أن بدأت في ملاحظة تغيير في مجرى الحديث والذي أخذ منعطفًا آخر، منعطف تعجبت من جرأة مايكل على طرحه، “أن كانت لديك الرغبة في الانضمام لنا، فنحن مجموعة من الأشخاص نمر جميعًا في ذات التيه والبحث عن حصادنا الأول لبذور زرعناها منذ زمن. بيد أنها تأبى في أن تنبت”.
حلت علي برهة من الزمن أضعت فيها جسدي، فما عدت قادرة على تحسسه في محاولة مستميتة مني لإنكار ما استمعت إليه، لماذا نطق بكل تلك الترهات وما الحافز الخفي وراءها. رددت عليه بحنق “وما الذي جعلك تجزم بأني كذلك”. عدل من وقفته كمن أراد أن يلتقط نفسًا لمحاولة اقناع شخص عنيد لا ينوي الاعتراف بغلطته “تسنى لي رؤيتك ساعة قدومك للمقهى والبدء في النقر على لوحة المفاتيح لكتابة ما ترغبين في كتابته، إلا أنكِ ظللت فترات طويلة تهربين من أداء تلك المهمة بعمل أي شيء يسحب البساط من أداء الغرض الأساسي لقدومك إلى المقهى. دون أن أغفل عن علامات الاستياء الكبيرة والبارزة للعيان تجاه ما تكتبينه”.
أردت الوقوف لمواجهته فقد أغدق علي بملاحظات لم أطق سماعها ناهيك عن جرأته واعتداده بنفسه وأن ما ينطق به هو الصحيح المطلق وغيره من الأقوال محض كذب وافتراء. بيد أني قد تمالكت نفسي في رسم ابتسامة صغيرة في محاولة بائسة لقبول آراء مناقضة لما أؤمن به. “لكن أليس الفعل الأول للكاتب هو كره ما يكتب” رجوت بذكري لتلك العبارة أن أوجه ضربة قاضية لمايكل رغبة مني في البحث عن ظفر متأخر، غير أنه رد بشكل لم أتوقع وتيرته ليردف قائلًا “صحيح لكن في العادة تكون فكرة مستحسنة أن كان الفاعل كاتبًا له نتاج ملموس يجعله في خضم مقارنات بين ما فات وما هو قادم. لكن في حالتك الوضع معاكس”.
مرة أخرى يجزم بأمر يخصني لا علم له به، ويدعي معرفته ببواطن الأمور. تلك النوعية من البشر تحترف استقراء الغرباء مع رمي إدعاءات قد تصيب وقد تخطئ. هدفهم الأساسي إبهار متعمد يجذب المتلقي ناحية التفاصيل الصغيرة التي أثبتت صحتها مع التغافل عن الأخطاء الكبيرة في تلك الرواية المحكية. وجدت نفسي وكلي رغبة في إغلاق جهاز اللابتوب والابتعاد بأكبر قدر ممكن من الأميال عن المدعو مايكل والذي أحس بدوره في رغبتي الجامحة في الإنسحاب. “لن أثقل عليكِ بالحديث، لكن لدي فضول في معرفة تاريخ ميلادك. أهوى كثيرًا ربط أحداث حصلت عند قدوم الشخص وبين ما يحصل معه في الوقت الحاضر” . لاح لي تفسير واضح لكل ما بدر منه، هو ممن يؤمنون بشدة بعلم الكونيات، كان علي أن استنتج ذلك منذ البداية، تنبؤاته التي ظل يلقيها على مسمعي، هدوءه القاتل والذي ينبأ بشخص روحاني يُعنى بعلم الماورائيات. بُحت له بتوقيت قدومي لهذا العالم، عن طريق ذكر جميع الأرقام التي تشير لتلك اللحظة؛ اليوم، الشهر، السنة. سكت قليلًا،سكت كمن أراد أن يربط بعض الأمور بعضها ببعض أو رغبة في التأكد قليلًا من أمر جلل. أخيرًا نطق لسانه ببعض الكلمات بعد هذا الصمت المريب “أتعلمين أنه ذات اليوم الذي ظهر فيها مذنب هالي؟”. أنا على علم بإسم هذا المذنب لكن تخفى علي بقية التفاصيل المتعلقة بمواعيد ظهوره وما يترتب عليه من أمور قد تصيب سكان الكرة الأرضية، ناهيك عن أنه مجرد جرم محلق في الفضاء قد يصطدم يومًا ما بكوكبنا أن حد عن المسار. “وهل تعتبره أمرًا حسنًا أم هو نذير شؤم” “لا يمكنني الجزم بإطلاق حكم مطلق، لكن قد يساعدكِ هذا الأمر أن اعتليتِ منصب قائدة جيش وقررتِ خوض حربًا ضد شعب آخر”.
عائدة إلى الفندق، ظل اسم مذنب هالي يتردد داخل رأسي. لم أستطع مقاومة إغراء النقر على الهاتف المحمول والدخول على صفحة جوجل والسؤال عنه، إلا أنه تملكتني لحظة ضعف أن يكون هنالك تفسير لا يروق لي أو أمر يجعلني نافرة على نحو لا يطاق. صحيح أن التطير ليس في حساباتي، أن استثنيت منها توجسي من شهري سبتمبر ومارس نظرًا لحدوث أمور جلل داخل نطاق أيامهما، غير أني أردت إشباع فضول لا أكثر والشعور بالأهمية كوني مشاركة في حدث كوني. كتبت العبارة المطلوبة ليظهر على وجه السرعة اقتراح بتحويلي إلى موقع اليوتيوب لمشاهدة أغنية بيلي إيليش – مذنب هالي. ارتحت كثيرًا لرؤية هذا الاقتراح لأغلق بعدها صفحة البحث وانطلق مسرعة للتجول داخل كوكب الأرض.